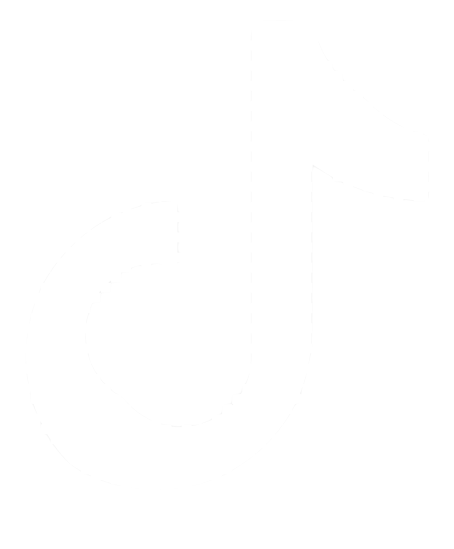أين لبنان من السيادة وهو يرزح تحت نير الاحتلال؟

كتب يوسف معوض في “Ici Beyrouth“:
بمجرد أن تطرح مسألة السيادة الوطنية، يبرز السؤال الجوهري حول هوية من يتولى زمام الأمور في لبنان، “فهل هو الفلسطيني أم السوري أم الإسرائيلي … أم الإيراني؟”
وفي الأصل، ماذا حلّ بموجات المتظاهرين المتدفقين إلى ساحة النجمة من الجامعة العربية والجامعة الأميركية، للتعبير بحماس غير مسبوق عن غضب الجماهير؟ ألم تشهد أحياء بيروت في وقت من الأوقات، على الاستجابة الكاملة لنداء المقاومة الفلسطينية ومختلف المنظمات المعارضة؟ ولكن أين هي اليوم، كل تلك الخطب النارية التي تحث الناس على الإنقلاب على السلطة لأنها تقيّد عمليات الفدائيين؟ عقب هزيمة حزيران 1967 وحتى اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975، برز الخط الفاصل بشكل قاطع بين الحلف الذي أراد وضع النشاط الفلسطيني تحت السيطرة للحفاظ على “لبناننا” العزيز، وأولئك الذين تمسكوا بضرورة منح منظمة التحرير الحرية الكاملة للقيام بعمليات “الكوماندوس” ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية! وفي ذلك الوقت، كان الجيش الوطني، حصن النظام والمارونية السياسية، في مرمى داعمي الثورة والقوميين العرب والديماغوجيين من اليسار العالمي. وردد هؤلاء شعارهم الشهير منذ العام 1970 على لسان الحشود، وكان كالتالي، حسب ما أتذكر: “ثوري يا بيروت ثوري، وخلي نجيم يلحق نوري”. وأتى الرد على هذه الاستفزازات، من خلال رسوم الغرافيتي التي غطت جدران شرق بيروت والتي شددت على أن “لبناننا لنا، ونحن أسياده”.
منذ ذلك الحين انقسم لبنان إلى قسمين، وعلق في هذا المستنقع مع مطالبة البعض بتخلي الدولة عن جزء من صلاحياتها، لصالح احتكار حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كامل أراضيها. ولكن حفاظاً على السلم الاجتماعي، هل كان من لا بد من إطلاق العنان للثورة الفلسطينية؟ يتمحور الخلاف في الأساس، حول مفهوم السيادة الوطنية. كما تجدر الإشارة إلى أن شيئًا لم يتغير منذ ذلك الحين وأن أي خلاف لبناني لا بدّ وأن يتمحور حول هذا السؤال نفسه.
استقلال أم تبعية؟
لا يخفى على أحد مفهوم “السيادة” كما عرفه لويس لو فور في نهاية القرن التاسع عشر، حيث استخدمت العبارة لتوصيف الدولة التي لا تخضع إلا لإرادتها الخاصة ضمن حدود القانون والمصلحة الجماعية. وبالتالي يرتبط مفهوم السيادة بوجود سلطة عليا، أي “سلطة مطلقة (يعتمد عليها الجميع) وغير مشروطة (لا تعتمد على أحد)”، وهذا ما ترجم بشكل واضح في النصوص الدستورية الفرنسية.
وبالتالي، الدولة التي تتمتع بالسيادة هي باختصار، تلك التي لا يمكن لدولة أخرى أن تجبرها على تبني سياسة قد تضرها أو تتعارض مع مصالحها الخاصة. لكن هل يستطيع لبنان ادعاء التمتع بالسيادة المطلقة؟ كيف ذلك وهو عبارة عن دولة عربية مجبرة على أن تأخذ المصالح الأخرى للدول العربية بعين الاعتبار.. علماً بأن بعضها بالكاد تتقبل فكرة أنه كيان مستقل.
أكثر من ذلك، كيف لنا أن ننسى أن الهوية والسيادة اللبنانية هما بحد ذاتهما مفهومان مزدوجان ومتشابكان لم يتفق عليهما مواطنونا قط. لذلك عندما طرحت القضية الفلسطينية بكل حدتها، وتحديداً بعد “أيلول الأسود” من العام 1970، حُكم على الأطراف المعنية، بمواجهة معينة على تراب الوطن. وذلك، على المدى الطويل. ثم امتدت المواجهة من منطقة الفنادق إلى بيروت فعينطورة في مرتفعات المتن، ومن خط المواجهة بين طرابلس وزغرتا، إلى العيشية في قضاء جزين، وسواها أيضاً.
وعلى أي حال، بغضّ النظر عن التبريرات اللاحقة والإقرارات المشبوهة، لا يمكن للّبناني أن يدعي التمتع “بسيادة” ما بينما يرزح تحت احتلال عسكري، سواء أكان ذلك في ظل منظمة التحرير الفلسطينية أو الردع العربي أو حتى إسرائيل.
خليل الجمل وجنازته
وبالعودة إلى العام 1968 ، عكفت منظمة التحرير على تنظيم شبكاتها السرية في مخيمات اللاجئين بدعم من النظام السوري. وبالتالي، ما عادت فتح تتردد بشن عملياتها من جنوب لبنان. وفي الأحداث، سقط المقاتل خليل الجمل ضحية نيران اسرائيلية وأقيمت له جنازة مهيبة في بيروت. اللافت أن المقاتلين الذين رافقوا رفات المقاتل كانوا يرتدون الزي الرسمي ويحملون السلاح، على مرأى من العالم كله، كأنما يطلقون تحد للنظام القائم. ثم طالبت المظاهرات التي أعقبت ذلك، بقيادة عناصر متطرفة، بالحرية وعدم تقييد عمل الفدائيين، وهو ما رفضته السلطات في ذلك الحين خوفًا من الانجرار إلى دوامة الانحدار.
حينها، توجه رئيس مجلس الوزراء عبد الله اليافي للحشود، وخاطبها مسطراً حرية العمل الفدائي. كان ذلك قبل وقت طويل من حادثة عين الرمانة في نيسان 1975، الحدث الذي أشعل شرارة بالحرب الأهلية اللبنانية، والتي اندلعت أيضًا تحت راية الحفاظ على خصوصيتنا ضد التدخل الأجنبي (الغرباء). وطوال فترة الاقتتال الداخلي الذي امتد على خمسة عشر عامًا، وفي الفترة التي تلت حتى يومنا هذا، بقي السؤال نفسه: “من الذي يتولى زمام الأمور في هذا البلد؟ هل هو الفلسطيني أم السوري؟ هل هو الإسرائيلي … أم هو الإيراني؟
وطبعت ثلاثة أحداث هامة فترة ما بعد الاستقلال، مؤكدة على المد والجزر على مستوى الهوية الوطنية وبالتالي على مستوى استقلالية دولتنا:
1- في أعقاب العدوان الثلاثي في تشرين الأوّل 1956 على مصر عبد الناصر، عقدت قمة بيروت العربية في 11 و 12 تشرين الثاني بحضور رؤساء الدول العربية. حينها، هدد الوزيران صائب سلام وعبد الله اليافي بالاستقالة في حال لم يقطع لبنان علاقاته الدبلوماسية مع المملكة المتحدة وفرنسا. ولكن الرئيس شمعون رفض الاستسلام للابتزاز وكلف سامي الصلح بتشكيل الحكومة الجديدة. لم تكن مصر قادرة على فرض موقفها على الرغم من التمرد في المناطق الداعمة للقضية الناصرية.
2- في 25 آذار 1959، جمع لقاء بين رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال عبد الناصر، ورئيس دولتنا اللواء فؤاد شهاب، في المصنع في ثكنة أقيمت في منطقة محايدة على الحدود اللبنانية السورية. وأكد رئيسا الدولتين حرصهما على الأخوة والتعاون المثمر. كان من المقرر تهدئة مخاوفنا وحساسياتنا الأخرى: لن يفرض أي رابط إقطاعي مع الجمهورية العربية المتحدة ( (RAU، وليس هناك من خطط لإضفاء الطابع الفنلندي على البلاد، على الأقل شكلياً. في ظل هذه الظروف التي شهدت ذروة سلطة عبد الناصر، يمكن اعتبار مثل هذا اللقاء اعترافاً من الجانب المصري بالكيان اللبناني، بينما بقي وجود هذا الأخير محط نزاع بالنسبة للأنظمة المتعاقبة في دمشق.
3- خلص اتفاق القاهرة في 3 تشرين الثاني 1969، والذي وقعه ياسر عرفات، ممثلاً منظمة التحرير الفلسطينية، وقائد الجيش اللبناني إميل بستاني، من جملة أمور أخرى، إلى “تسهيل العمل الفدائي عن طريق تسهيل المرور للفدائيين وتحديد نقاط مرور واستطلاع في مناطق الحدود وتأمين الطريق إلى منطقة العرقوب باتجاه “فلسطين المحتلة”. وخلال الغزو الإسرائيلي للبنان في العام 1982، تمكن الإسرائيليون بسهولة من الادعاء أن هذا الاتفاق انتهك وأبطلت اتفاقية الهدنة اللبنانية الإسرائيلية التي تعود لعام 1949.
في المثالين الأولين المذكورين أعلاه، تم حفظ الشرف وأثمر الحزم عن نتيجة، وربحت القضية ولو بعد معركة شاقة. بينما في الحالة الثالثة، أضر اتفاق القاهرة بالسيادة الوطنية التي لا يمكن تقاسمها من الناحية القانونية.
بلا مقدمات..
ثم فجأة، في 6 نيسان من هذا العام، تستهدف بعض الصواريخ شمال إسرائيل.. المصدر، الأراضي اللبنانية.. فيأتي رد الفعل محتسباً بعناية ودقة.. وعلى الرغم من أن صحيفة “هآرتس” العبرية نقلت عن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن ضباطاً إيرانيين بارزين من فيلق القدس هم الذين نسقوا بالفعل هذا الهجوم مع حماس، سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها. كأن شيئاً لم يكن! لم نلحظ أي ردة فعل تعيدنا بالذاكرة إلى تلك المرحلة “العظيمة” حيث ما كانت لعاصمتنا ولمدن الساحل الأخرى بين عامي 1967 و 1975، أن تصمت إزاء عدم كفاءة ولامبالاة الدولة اللبنانية!
فما الذي عساه تغير منذ ذلك الحين؟ وما الذي يخفى وراء مسالمة حزب الله والنشطاء الذين يتحكّم بهم؟
في الحقيقة وباختصار، لم يعد أحد مستعداً للموت من أجل فلسطين، منذ ترسيم الحدود البحرية لا بل وحتى قبل ذلك بوقت طويل!
مواضيع ذات صلة :
 حارس مرمى إسرائيلي متهم بالاعتداء الجنسي في اليونان |