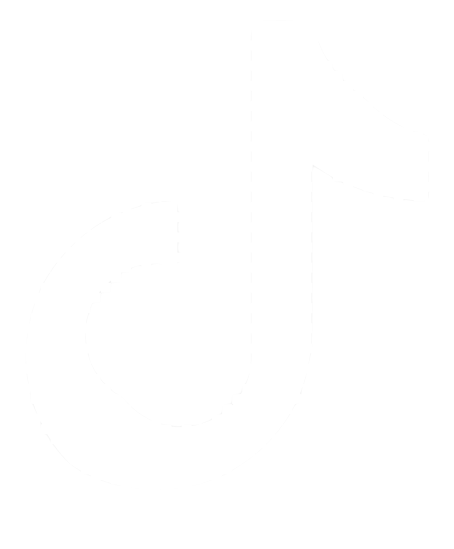ما بعد الصدمة: الناجون.. في دوامة المعاناة

كتب “David Sahyoun” لـ“Ici Beyrouth”:
في هذه الأوقات التي يطغى عليها رعب العنف والحروب، تعود الصدمات و”الكدمات” النفسية إلى الواجهة، حيث تنقلب حياة الضحايا بأكملها رأساً على عقب.
في هذا المقال، محاولة لاستكشاف الجوانب المختلفة للمحنة وطرق النهوض المحتملة.
الخميس 17 تشرين الأول 2024، عُثر على سيمون فيشي، مدير الموقع السابق لصحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية، ميتاً. وبينما بقيت أسباب الوفاة مجهولة، تجدر الإشارة إلى أن فيشي نفسه عانى في 7 كانون الثاني 2015 من إصابات خطيرة في الهجوم الذي وقع في باريس. وإن ذكرت حالته ههنا، فذلك لأنها تسلط الضوء على العواقب النفسية الوخيمة التي تثقل كاهل الناجين من الهجمات أو الحروب. ويعكس مصير سيمون فيشي مثال العديد من الناجين الآخرين، المجهولين بشكل عام، والذين يعيشون حتى اليوم، ويلات الحرب ويختبرون الزلازل النفسية الحقيقية.
وعلى الرغم من اختلاف الظروف والحالات، يبقى شبح المعاناة هو نفسه. وبعيدًا عن الآثار الجسدية، يعاني الناجون من الآثار النفسية والاضطرابات التي تبقيهم في حالة من الصراع الداخلي. تطاردهم ذكرى أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم، الذين أصيبوا أو ماتوا أمام أعينهم، ويستهلكهم الشعور بالذنب لمجرد نجاتهم، وتراودهم الكوابيس ونوبات القلق وأنواع الرهاب المختلفة. وتترسخ الصدمات أكثر فأكثر كلما تكررت المشاهد المؤلمة على الرغم من المحاولات اليائسة للتحكم بالتجربة وعدم تلقيها بشكل سلبي.. يحاول الضحايا من خلالها التعبير بالكلام عن تجارب لا توصف، كما يتضح من قصص الضحايا.
وتنعكس آثار الصدمات الشديدة على الحياة الشخصية والمهنية والاجتماعية لهؤلاء الناجين، حيث يعجز البعض عن العودة إلى حياته الطبيعية، ويعيش بشكل منعزل، فريسة للأفكار المظلمة ويفقد توازنه تدريجيًا قبل أن يغرق إلى الأبد.
ويركز التحليل النفسي على الصدمات في قلب العصاب، حيث تطغى الإثارة الشديدة على القدرة على التواصل والترميز، وكأنّ الفرد تعرض لجسم دخيل يستحيل استيعابه في الداخل، ولا يكف مع ذلك عن التطفل.. في لحظات معقدة ليلاً نهاراً. وبينما يضاعف الضحايا الجهود لقمع أو إنكار الذكريات المؤلمة لتجنب الألم، لا يقومون فعلاً إلا بمفاقمة الأعراض التي تظهر بشكل كوابيس وذكريات الماضي، واليقظة المفرطة. حتى أنّ الصدمة تسقط على الزمانية التي تحدد بـ”ما بعد الصدمة”. حيث قد لا يبدو الحدث صادماً في وقت حدوثه، لكن آثاره تتجلى في وقت لاحق، عندما يرتبط بتمثلات لاواعية ويعيد تنشيط الصراعات السابقة. وهذا ما يفسر الفجوة التي غالبًا ما تتم ملاحظتها بين التفاهة الواضحة لحدث ما وعواقبه النفسية المدمرة.
وأتت فكرة الصدمة من شاندور فيرينتزي، حيث تمزق الصدمات غير المتوقعة الذات وتترك جروحاً لا تأنف تتعمق وهوية مشرذمة. بالنسبة لوينيكوت، يصطدم الشخص الذي يعاني من الصدمة “بالخوف من الانهيار”، والخوف من تكرار الحدث، مما يؤدي في النهاية إلى إغراقه في العذاب.
ويرى جاك لاكان أنّ الضحية كأنما تلقى في غياهب “الصدمة”، حيث تختبر تجربة الموت النفسي التي تفلت من أي رمزية. فيشعر الشخص المصاب بالوقت يتوقف ويتحجر خوفاً من اللحظة المأساوية. ويعاني من صعوبة مواجهة واقع يستحيل التعبير عنه، وتفلت منه المعاني والكلمات. يتصارع الشخص مع تأثيرات شديدة ومتناقضة من الرعب والعار والشعور بالذنب والغضب دون أن يستطيع ترجمتها بالتعبير.
وتزلزل الصدمة أسس الهوية والمعتقدات الأساسية التي تمنح للوجود معنى. ومعها، ينهار الوهم بالحصانة والثقة بعالم يُنظر إليه عموماً على أنه آمن ومتماسك. وتبقى الضحية بمواجهة التعسف والهراء وهشاشة الأشياء. ومنذ ذلك الحين، يجتاح الضحايا شعور شديد بعدم الأمان وانعدام الثقة. يصبح العالم ساحة تهديدات لا يمكن التنبؤ بها. وقد يُنظر للآخرين كتهديد محتمل. فيعزل الشخص نفسه، وينسحب، مع بقائه في حالة تأهب دائم، يقفز عند أدنى ضجيج، مذعوراً من فكرة تكرار محتمل للمأساة. ويعد تجنب الرهاب أحد أعراض ما بعد الصدمة، تمامًا مثل الاسترجاعات المتطفلة. وهذه كلها علامات، تضاف إلى ما ذكر، تنبه للضيق النفسي الذي يعيشه هؤلاء الأشخاص.
وهناك علامات أخرى، أقل وضوحاً ولكنها مليئة بالمعنى. أولاً، الاضطرابات الاكتئابية، مع ما يصاحبها من حزن، والنقص في الحافز وعدم القدرة على الاستمتاع والتباطؤ الحركي النفسي، والأفكار المظلمة.. معاناة يحفزها الحداد المستحيل على المتوفى، وفقدان جزء من الذات بالتوازي. وأمام هذا الطوفان النفسي، محاولات ذاتية للتطبيب، ومحاولات يائسة لتخدير الألم النفسي الذي لا يطاق.. بالكحول والمخدرات والأدوية وسواها من المواد لإبعاد الصور والعواطف التي لا تطاق.
وقد تبرز لدى البعض إحدى العلامات الأكثر إثارة للقلق التي يجب مراقبتها: الأفكار الانتحارية التي تظهر كإغراء لوضع حد لوجود خالٍ من المعنى وللمعاناة التي لا تنتهي. ذلك أنه بعيدًا عن الصدمة نفسها، هي ديناميكية الحياة بأكملها التي تتغير وتهتز الروابط مع الآخرين، وتفقد الاستثمارات السابقة (العمل والترفيه والمشاريع) نكهتها وسبب وجودها. يبدو المستقبل بلا أفق، ويختزل بتكرار ممل ومؤلم.
وتفرض هذه المعاناة الحادة الحاجة لرعاية علاجية طويلة الأمد قد تجمع بين أساليب متعددة. ويتمثل التحدي في السماح بالاستئناف التدريجي للحياة النفسية وإعادة إطلاق عمليات التعبير التي تعطلت.
ومن هنا أهمية (إعادة) بناء مساحة تحفز ضمن العلاج، على التعبير الكلامي، حيث يمكن تسمية هذه التأثيرات وتصويرها ومشاركتها. وتوفر مساحة العلاج في التحليل النفسي مكانًا للاستماع اليقظ، واسترجاع الذكريات المؤلمة دون ضغط ولا هروب، ودمجها تلقائيا في إطار سردي، وإدراجها في تمثيلات قابلة للمشاركة. وبالتوازي، لا بد من محاولة استقلاب التأثيرات الفائضة وتسجيلها في تمثيلات قابلة للمشاركة: الكوابيس المتكررة والأحاسيس الجسدية المزعجة والقلق الذي لا يوصف، كلها عناصر لا بد من تناولها وتوضيحها والإشارة إليها.
بهذه الطريقة، يمكن دعم الموارد الإبداعية للشخص ومحاولات تشكيل التجربة المؤلمة وفهمها.. وذلك من خلال الكتابة والرسم والتحدث ولعب الأدوار والتعبير الإيمائي، كل الطرق جيدة لمحاولة كبح الخوف، ومنحه وجهًا إنسانيًا. أما التحدي الآخر فيرتبط بالمساعدة على خوض الحداد.. هذه الرحلة الفريدة تسمح بفصل النفس عن الشيء المفقود دون الضياع في سواد الحزن.. الحداد على الأحباب المفقودين، ولكن أيضًا الحداد على جزء من النفس فقدناه في المأساة، والحداد على عالم ربما ضاع للأبد بالنسبة للبعض. إنها عملية طويلة ومؤلمة، تتكون من لحظات فوضوية ومن فترات هدوء تدريجية.
لكن عملية إعادة التأهيل والنهوض نتاج رحلة طويلة ووعرة، نصطدم فيها بإغراء العدم والخوف من العودة إلى التجربة الصادمة. تتكرر فيه الانتكاسات الاكتئابية أو الإدمانية، وتصل الحركات الانتحارية فيه إلى حد مدمر في بعض الأحيان. ومن هنا أهمية الدعم طويل الأمد، الذي يسمح بالتعاطي مع أوقات الصدمة بالوتيرة الأنسب.
في نهاية المطاف، يبقى الهدف الأساسي من العلاج إعادة إطلاق حركة الحياة والرغبة والثقة بالمستقبل وإعادة اكتشاف معنى الأشياء والروابط ومتعة المشاريع… عمل كامل من إعادة الاستثمار المندفع لإنجازه، بحيث يصبح المستقبل مرغوبًا من جديد.
تذكرنا مصائر الناجين من الهجمات أو الحروب بهشاشة الحياة النفسية بمواجهة عواصف التاريخ. وتسلط الضوء على الحاجة المطلقة للتعبئة الجماعية والعمل الثقافي في مواجهة الرعب. لأنها بالفعل معركة على المحك، معركة لا بد وأن ينتصر فيها محرك الحياة على قوى الموت والدمار.
في هذه الأوقات المضطربة من عمر العالم، يلعب التحليل النفسي أكثر من أي وقت مضى، دوره الهام في الغوص في الحالات المتطرفة وتوفير مساحات للمناقشة ولتبديد الغموض. ويبرز كبوصلة كفيلة بتوجيه النفوس في أحلك الأيام المطبوعة بالصدمات.. ويبقي حياً في النفوس.. ذلك الأمل بأنّ الحياة لا بد وأن تنتصر!