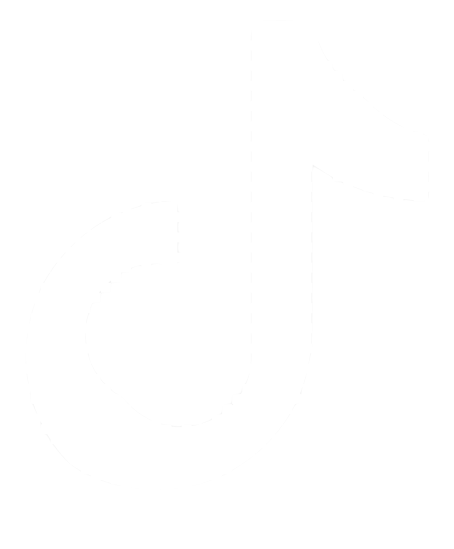“رفع السرية المصرفية”… مغالطات بالجملة ومفعول رجعي “كارثي”!

الإصلاح الحقيقي لا يُفرض بالقوة، ولا يُنتزع من خلال إجراءات استثنائية، بل يُبنى بتأنٍّ، عبر ترميم المؤسسات، وتفعيل ما هو موجود من قوانين، لا عبر إعادة تفصيلها على مقاس اللحظة السياسية أو المزاج العامّ. وإنْ كانت النوايا صادقة في محاربة الفساد، فالأجدر بالحكومة والبرلمان أن يُفعِّلا النصوص القانونية القائمة، وأن يُحصِّنا القضاء من التدخلات، لا أن يشرِّعا ما قد يتحوّل إلى أداة انتقامٍ سياسيّ أو ماليّ.
كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:
يُطرح حاليًا على طاولة المجلس النيابي اللبناني مشروع تعديل جديد لقانون السرّية المصرفيّة، قد يحمل تغييراتٍ جوهريةً تُعيد رسم معالم العلاقة بين المواطن، والدولة، والمصارف. هذه الخطوة، التي تأتي في خضمّ أزماتٍ ماليةٍ واقتصاديةٍ غير مسبوقةٍ يمرّ بها لبنان، تُعدُّ محاولةً لإعادة ترميم الثقة بالمؤسّسات ومكافحة الفساد، كما يُروِّج لها البعض. إلّا أنّ ما يثير الجدل اليوم ليس فقط مضمون هذه التعديلات، بل ما هو أخطر وأعمق: تبنّي الحكومة لمفعولٍ رجعيّ يُجيز للجهات المعنية النفاذ إلى بياناتٍ مصرفيةٍ تعود لفتراتٍ سابقةٍ، وهو ما يطرح تساؤلاتٍ قانونيةً وأخلاقيةً وواقعيةً بالغةَ الحساسيّة.
فهذا التوجّه، الذي يضع في مهبّ الريح مبدأً قانونيًا أساسيًا يقضي بعدم رجعيّة القوانين، قد يُحدث زلزالًا على مستوى الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، لا سيما في أوساط المستثمرين والمودعين الذين بنوا خياراتهم المالية في ظلّ نظامٍ قانونيّ محددٍ وواضحٍ. أن تُفتَح حساباتهم الماضية اليوم على مصراعيْها، بعد أن كانت مشمولةً بالحماية، هو أشبه بإعادة كتابة القواعد بعد انتهاء اللعبة.
من هنا، لا يبدو أن مشروع القانون الجديد، على الرَّغم من نواياه المعلنة، ينفصل عن السّياق السياسي العام الذي يشهد انعدام ثقةٍ متزايدٍ بين المواطنين والدولة، ويُعيد إلى الواجهة مخاوف قديمة من استخدام القانون كأداة ضغطٍ وانتقامٍ سياسيّ. فهل نعيش لحظة إصلاحٍ حقيقيّ؟ أم لحظة تصفية حسابات مُقنّعة؟
من قانونٍ محصّنٍ إلى سلاحٍ ذي حدّيْن
لطالما شكّل قانون السرّية المصرفية ركنًا أساسيًا في المنظومة الاقتصادية اللبنانية منذ إقراره عام 1956، وجعل من لبنان ملاذًا ماليًا للكثير من المستثمرين العرب والدوليين، وركيزةً أساسيةً للثقة بالنظام المالي الوطني. فقد وفّر هذا القانون غطاءً قانونيًا للخصوصية المصرفية، وأسهم في جذْب الرّساميل، في ظلّ محيطٍ إقليميّ غالبًا ما كان يفتقر إلى الاستقرار السياسي والضمانات القانونية.
حتّى مع التعديل الذي طرأ عليه عام 2022، بقي التوازن قائمًا، ولو بشيء من الحذر: تمّ توسيع صلاحيات الجهات المخوّلة طلب رفع السرية المصرفية، لكن ضمن إطارٍ محددٍ، ولغاياتٍ واضحةٍ، أبرزها مكافحة الفساد، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال. وتمّ التأكيد أنّ هذه الصلاحيات لا تُمارَس بشكلٍ عشوائيّ، بل تستند إلى إجراءاتٍ قضائيةٍ وقانونيةٍ مضبوطةٍ.
لكنّ المشروع الجديد يُحدث تحوّلًا نوعيًا وخطيرًا في هذا التوازن، إذ يفتح الباب لاستخدام القانون بأثرٍ رجعي، متجاوزًا المبادئ الدستورية التي تُعدّ بمثابة صمّام أمان قانوني للأفراد والمؤسسات. وهذا يطرح تساؤلاتٍ جوهريةً لا يمكن تجاهلها: لماذا لم تُفَعِّلْ الجهات المعنيّة – من قضاء، وهيئات رقابية، ومؤسسات رقابة مالية – صلاحياتها التي مُنحت لها بموجب تعديل 2022؟
هل يعود الأمر إلى خللٍ في آليّة التطبيق؟ أم أنّ النّص القانوني كان كافيًا لكنّ الإرادة السياسية كانت غائبة؟ أم أنّ هناك مَن يتعمّد الإبقاء على هذه الأدوات مُعطّلةً، ليُعاد تفعيلها الآن في لحظة سياسية حسّاسة، عبر مشروعٍ يُعيد تشكيل القانون بما يتناسب مع ظرفٍ معيّنٍ لا مع مبدأ ثابت؟
أسئلة مقلقة، خصوصًا إذا ما اقترنت بتجارب سابقة أظهرت كيف يُمكن أن تُستخدمَ القوانين الانتقائية في لبنان كأدواتٍ لتوجيه الاتهام أو تبرئة أطراف، وفق ميزان سياسي لا قضائي.
المفعول الرجعي: انزلاق خطير
منح التعديل الجديد مفعولًا رجعيًا يعني عمليًا السماح للجهات المخوّلة بالوصول إلى بيانات مصرفية تعود إلى سنوات خلت، بما في ذلك أسماء العملاء، حركة الحسابات، التحويلات، وأحيانًا حتّى تفاصيل ترتبط بطبيعة الأنشطة التجارية أو الشخصية. وهذا يُعتبر، في القانون، خرقًا واضحًا وصريحًا لمبدأ “عدم رجعيّة القوانين”، أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام قانوني عادل.
فهذا المبدأ ليس ترفًا قانونيًا، بل ضمانةً لحقوق الأفراد، تُرسّخ فكرة أنّ الإنسان لا يُحاسَب على أفعال تمّت في ظلّ قوانين لم تكن ساريةً آنذاك. الرجعية في القانون ليست فقط اعتداءً على الماضي، بل تهديدًا للمستقبل، لأنّها تزرع الشكّ في استقرار البيئة القانونية وتجعل من كل قاعدةٍ قابلةٍ للتعديل بأثر يعود إلى الوراء، وفق الحاجة أو المصلحة.
وما يزيد الطين بلّة هو أن هذا الطرح يأتي في وقتٍ تعاني فيه الدولة من فقدانٍ شبه تامٍّ للثقة، ويعيش فيه القضاء أزمة استقلالية، وتفتقر فيه المؤسسات إلى الشفافيّة والرّقابة الفعليّة. ما يعني أن المفعول الرجعي، ولو أُقرّ تحت شعارات سامية كمكافحة الفساد، قد يتحوّل إلى أداة تصفية حسابات سياسية، أو وسيلة ابتزاز موارِبة، في لحظةٍ سياسيةٍ حسّاسةٍ ومشحونةٍ.
الأسئلة هنا كثيرة ومقلقة: من الجهة التي ستُشرف على تنفيذ هذا القانون؟ من سيضع الضوابط؟ من سيضمن عدم استغلال هذه الصلاحية في غير موضعها؟ وهل الحكومة فعلًا على استعداد لإصدار مراسيم تطبيقية دقيقة وواضحة، تُحدّد الأطر، وتمنع التسييس والتجاوزات؟ أم أننا أمام نصوصٍ فضفاضةٍ تُفتح على احتمالاتٍ لا تُحصى، وتُترك للتفسير المزاجي أو السياسي؟
في غياب أجوبة صريحة وواضحة، يصبح المفعول الرجعي قنبلةً موقوتةً، لا أداة إصلاح، وقد يكون ثمنها باهظًا على ما تبقّى من النظام المصرفي، والبيئة الاستثمارية.
الثقة تُبنى ولا تُنتزع
إنّ المسَّ بسرّية الحسابات المصرفية بأثر رجعي، حتى لو تمّ تحت راية مكافحة الفساد، لا يُمكن اعتباره خطوةً إصلاحيةً خالصةً، بل قد يُفهم – وبحقّ – كضربةٍ إضافيةٍ لما تبقى من النّظام المالي اللبناني. فمثل هذه الإجراءات تُرسِل إشاراتٍ سلبيةً بالغة الخطورة، ليس فقط إلى الداخل، بل إلى كل مستثمرٍ أو مودِعٍ.
المشكلة أنّ الأسواق لا تميّز كثيرًا بين نيّة الإصلاح واستخدام القانون كذريعةٍ لفرض أمرِ واقعٍ. فما إنْ يشعر المستثمر أو صاحب رأس المال أن أمواله قد تُستهدف مستقبلًا عبر قوانين تُطبَّق بأثر رجعي، حتّى يبحث عن ملاذٍ أكثر أمانًا. وهكذا، يُضاف إلى الانهيار النّقدي، انهيار أخلاقي في العقد الضمني بين الدولة والمواطن، بين البنك والزبون، وبين القانون والثقة.
القول نعم للشفافية والمحاسبة لا يتعارض إطلاقًا مع حماية الخصوصية، بل يتكامل معها. فالمحاسبة الحقيقيّة تُمارَس في إطار قانوني متماسك، شفّاف، يُطبَّق على الجميع بلا استثناء ولا انتقائية. أمّا أن يُرفعَ الغطاء عن حسابات الناس من دون معايير واضحة، ومن دون ضمانات قضائية مستقلة، فهذا لا يُشبه الشفافيّة، بل يُشبه التعرية القانونية، وهو أمر لا يُمكن تبريره لا بالسياسة ولا بالاقتصاد.
الإصلاح لا يكون بإلغاء الخصوصيّة، بل بإعادة الاعتبار للمؤسّسات. بالتمكين لا بالتعرية. ببناء قضاء مستقل وهيئات رقابية نزيهة، قادرة على مساءلة الفاسدين بفعالية لا بمفعول رجعي، ووفق أدوات قانونية قائمة لا مستحدثة على عجل.
فالثقة لا تُسترجَع بالقوة، بل تُبنى بالوقت والالتزام. وهي، في زمن الأزمات، أغلى مِن كل الموارد المالية التي يحاول النظام استعادتها بأثر رجعي.
الإصلاح لا يُفرَض… يُبنى
إنّ مشروع تعديل قانون السرية المصرفية بصيغته الحالية، وبما يتضمّنه من مفعول رجعي، لا يُعدّ مجرّد خطوة تقنية في سياق إصلاح مالي، بل يُمثّل انحرافًا مقلقًا عن المبادئ الدستورية والحقوقيّة التي تحكم أي نظام قانوني سليم. فحين يُستبدل مبدأ عدم رجعيّة القوانين بقاعدة جديدة تُتيح النّبش في الماضي المالي للأفراد، بلا ضمانات كافية، فإننا نكون قد انتقلنا من منطق العدالة إلى منطق الإجراء، ومن منطق الإصلاح إلى منطق السيطرة.
الإصلاح الحقيقي لا يُفرض بالقوة، ولا يُنتزع من خلال إجراءات استثنائية، بل يُبنى بتأنٍّ، عبر ترميم المؤسسات، وتفعيل ما هو موجود من قوانين، لا عبر إعادة تفصيلها على مقاس اللحظة السياسية أو المزاج العامّ. وإنْ كانت النوايا صادقة في محاربة الفساد، فالأجدر بالحكومة والبرلمان أن يُفعِّلا النصوص القانونية القائمة، وأن يُحصِّنا القضاء من التدخلات، لا أن يشرِّعا ما قد يتحوّل إلى أداة انتقامٍ سياسيّ أو ماليّ.
إنّ دعوة النواب والجهات المعنية اليوم لا يجب أن تقتصر على مناقشة مشروع قانون، بل يجب أن تكون وقفة ضمير أمام مسؤوليات وطنية كبرى. فلبنان، الذي فقد الكثير من مقوّماته الاقتصادية، لا يحتمل خسارة ما تبقّى من ثقة، سواء بثروته البشرية، أو بطبقته الاقتصادية، أو حتى بسمعته المصرفية التي كانت ذات يوم رافعة استقرار.
حماية الثقة ليست ترفًا. إنها العمود الفقري لأي نهوض اقتصادي. ومن دونها، لا استثمار، ولا رساميل، ولا استقرار. ولهذا، فإنّ الإصلاح لا يكون بتعريتها، بل بتحصينها.