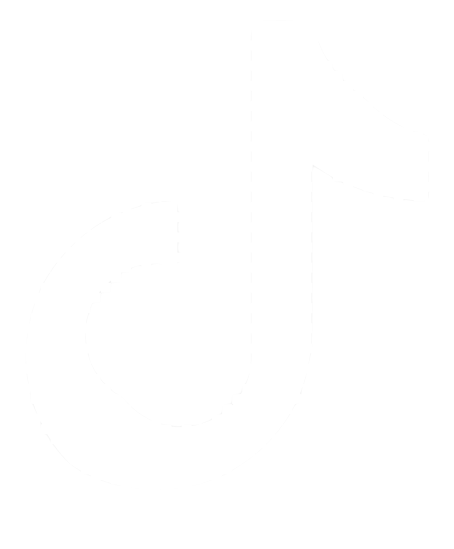ثقافة مضادة.. لا أكثر ولا أقل!

ما الذي يعنيه الاختلاف؟ هل يشكل ثقافة فرعية أو يمنحنا حق “التميز”؟ هل يمكن لخرق في النزعة الانفصالية المذهبية اللبنانية تبرئة الدين من الفظائع التي ارتكبت باسمه؟
كتب يوسف معوض لـ”Ici Beyrouth“:
في جلسة لي مع أحد المحاورين، اختزل محاوري الوضع في لبنان بـ “حرب بين ثقافتين، يضاعف الصراع العالمي من حدتها”، دون الانتباه للتفاصيل الدقيقة.. تفسير بسيط لدرجة أن صاحب فرضية “صراع الحضارات”، صموئيل هنتنغتون كان ليرفضه بدوره. فكيف يمكن أن نفسر الخلافات على الساحة اللبنانية بالخلافات غير القابلة للاختزال على الساحة الدولية؟
يصعب التصديق أن هناك صدام ثقافي بين الأحياء الشرقية والغربية لبيروت، كما كان الحال حتى الستينيات بين الجزائريين من أصل أوروبي وجيرانهم في مدينة القصبة. كما لا ينبغي الخلط بين هذا الخلاف وبين الأزمة البلجيكية على خلفية الصراع اللغوي أو الصراع الدموي بين البروتستانت والكاثوليك في لندنديري!
بصفتنا مواطنين في هذا العالم، يمكننا أن ننكر الاختلاف بين الجماعات باسم وحدة الحالة البشرية ووحدة الثقافة العربية والوطنية التي تتجاوز الخصوصيات والعلمانية التعويضية. لكن لا يمكننا أن نتحدى، باسم أيديولوجية علمانية أو يعقوبية، حق مجتمعات معينة بتحديد هويتها الخاصة في عالم حطم بالفعل الجدران لصالح امتزاج الشعوب.
حصون نموذجاً للتعايش
بات بإمكان عايدة كنفاني زهار أن تحتفل: لقد تمكنت من إيجاد خرق في النزعة الانفصالية الطائفية اللبنانية، مثل قرية حصون المختلطة (قضاء جبيل)، حيث ساعد الشيعة والموارنة بعضهم البعض في الأوقات الصعبة، وحيث “توطدت أواصر التعايش” حتى خلال الحرب الأهلية. ومع ذلك، تشكك إحداهنّ: “عسى أن يستمر الوضع هكذا!”. لكن لنتخيل السيناريو المحتمل الذي يؤسس فيه حزب الله في القرية نفسها، إحدى مؤسساته السياسية والعسكرية والدينية المتعددة أو حتى مكتباً للقرض الحسن كما فعل في بلدة عمشيت الهادئة! ما الذي سيحدث حينها للتفاهم الودي الذي يحتفى به منذ أكثر من عشرين عامًا في “أنثروبولوجيا البحر الأبيض المتوسط”؟
كما سعت زهار، عالمة الأنثروبولوجيا، بكرم كبير لتبرئة الدين أمام محكمة الضمائر من الفظائع التي ارتُكبت باسمه! وذهبت إلى حد القول إن العنف أتى نتيجة استغلال الدين من قبل قادة الميليشيات الذين بنوا على الجانب الذي يفرق وأفرغوا الدين من مضامينه الجامعة.
الاتفاق مع هذا الرأي يعني الاعتراف بوجود فصل واضح بين السياسي والديني، وهذا أمر قابل للنقاش إلى حد كبير! وكذلك يمكننا دحض تأكيدات عائدة كنفاني زهار وافتراض أن الدين قادر على إفساد السياسة أيضاً بواسطة شحناته العنيفة. ومن ثم وقبل كل شيء، ما زلنا لم نجد إجابة عن الاستفسار المتعلق بقدرة مجموعة ما على أن تدعي، بالاعتماد على هويتها الدينية المحددة، أنها تنتمي إلى ثقافة مختلفة عن تلك التي تسود في بيئتها المباشرة. هذا هو الحق بالإختلاف، أليس كذلك؟
اختلافات من العدم تقريباً..
بالطبع، لطالما صورت “الاختلافات المجتمعية على أنها أساسية وجذرية في لبنان: ديانتان وثقافتان وطريقتان للحياة”. بالطبع، ولكن سيكون من الصعب التأكيد على أنه طالما أننا ننتمي إلى نفس الحضارة، لا يمكننا المجادلة في ترسيخ السمات المميزة للخلافات أو إدعاء إدارتها بشكل محدد، خارج إطار التقارب المادي والعادات ومشاركة اللغة العربية الأم. ومع ذلك، يمكن تجميع هذه الاختلافات معًا ضمن فئة أو تحت مسمى الثقافة المضادة. وتعرّف هذه الأخيرة على أنها ثقافة فرعية “تشترك فيها مجموعة من الأفراد تتميز بمعارضة واعية ومتعمدة للثقافة السائدة”. وليست “القرابة الإبراهيمية” قادرة على محو الصدع الذي لا يمكن التغلب عليه والذي حفرته الأنظمة الصارمة التي تحكم وضعنا كمسيحيين أو كموحدين مسلمين، في هذا البلد كما في سواه. وطالما أن الزيجات المختلطة بين أبناء الديانات المختلفة لم تصل إلى نسبة عالية وطالما أنها تندرج تحت سجل الاستثناء فقط، فسيُحكم على مجتمعاتنا بالنظر إلى بعضها البعض بعين الريبة.
تكاد اختلافاتنا المزعومة تأتي من العدم، ومن هذا المنطلق، تشكل خطورة وتستدعي المزيد من الحيطة والحذر. قد يسأل الفريق المسيطر فريق الأقلية لماذا التشبث بهذه “اللا أدرية” في ظل التشابه بين الاثنين؟ وفقاً للمفكر جنكيليفيتش، يطلق سوء الفهم حول “العدم” هذا، العنان للعواطف وللإغراء الشيطاني الذي يسعى للقضاء على أي اختلاف من خلال مهاجمة أولئك الذين يرسخونه.
الفتح الإسلامي والثقافة المضادة
نشهد في بلادنا منذ القرن التاسع عشر، صراعًا بين غرب منتصر وشرق ينتهج موقفاً دفاعياً، بين قهر الحداثة والأصالة الأصلية. لقد انتصر تغريب الأعراف منذ النهضة، من خلال فرض النماذج الغربية التي أتى فيها رد الفعل الديني السياسي لإثبات نفسه في ميدان النضال. ثم مع ثورة الخميني الإسلامية وتعنت بن لادن وداعش، استعاد الحجاب وهو أحد أكثر الرموز ظهوراً، وجوده في الساحات العامة بعد القضاء عليه فعلياً. منذ ذلك الحين، تجلى الاسترداد الإسلامي بشكل حازم في جميع الطبقات الاجتماعية ولم يفوت فرصة للتأكيد على ظهوره على الساحة العامة. وليس الخلاف حول ملابس السباحة في صيدا سوى مثال على ذلك، تمامًا مثل زيارة الأساقفة المسيحيين لمليتا.
ما قلته للتو لا يدعم موقف محاوري الهنتنغتوني الذي ذكرته في البداية، فحروبنا الصغيرة ليست امتدادًا طبيعيًا لرؤية صاخبة على نطاق عالمي. ومع ذلك، لا تتكون أي ثقافة نتيجة عمليات استحواذ لا رجعة فيها، بل هي أيضًا إسقاط ورغبة وقصد. أولئك الذين اختاروا بشكل نهائي النموذج الغربي خارج البحر الأبيض المتوسط يختلفون إلى حد ما عن أولئك الذين اختاروا النموذج المستورد من المرتفعات الإيرانية أو السهوب القاحلة تقريبًا في المناطق النائية السورية. نحن لا نمسح بضربة قلم ومن باب الحياء، “الثقافة المضادة المسيحية” في لبنان المتعدد. إن ربط اختلافاتنا بالمتغيرات الدينية لهو اختزالي. ولا يمكن رفض الاختلاف أو عدم الاعتراف بشرعيته بحجة أنه لا يتلاءم مع جدول تفسير أيديولوجي. الاختلاف موجود والأمر متروك لنا لإدارته. والسلم الأهلي يمثل قضية المواجهة بين مرونة الأقليات النشطة والإمبريالية الثقافية للجماعات المهيمنة أو التي تدعي أنها كذلك.