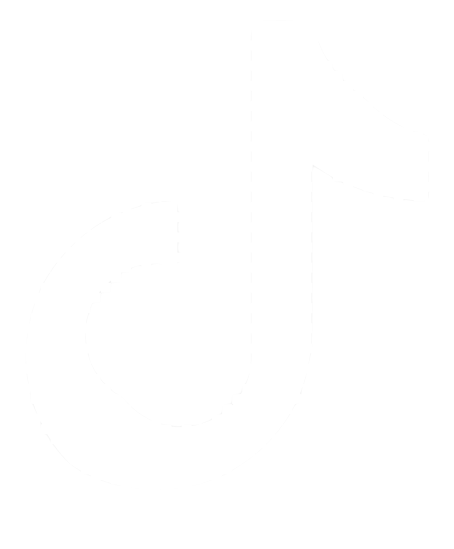استعادة الأموال المنهوبة بين الحقيقة والخيال

ترجمة “هنا لبنان”
كتب نيكولا صبيح لـ”Ici Beyrouth“:
في بدايات “الثورة”، انتشرت فكرة استعادة الأموال المنهوبة بشكل كبير، حتى أنّ البعض ذهب في ذلك الحين إلى حد طرح أرقام لا تستند إلى أي شيء على الإطلاق. وعقدت الآمال على هذا المال، الذي افترض أنه بمجرد استرداده، سيغطي الديون والودائع المفقودة وسينعش الاقتصاد اللبناني ويعيد الحياة إليه.
ويبدو أن الجميع تفنّن، بغياب أي خريطة طريق على الإطلاق، بتوزيع الافتراضات كما يحلو له.. افتراضات لا تكلف شيئًا، وتترك صدى جيداً في أذهان الضحايا، وربما تحفز المزيد من التصفيق.
لكن الضجيج خفت تدريجياً وسرعان ما غابت هذه القضية. وبالمقابل، تم الإكتفاء، ربما من باب راحة الضمير، بإدراج فقرة صغيرة حول استعادة الأموال في “الخطط” المختلفة.. والتي تفتقر إلى الإقناع. ومن هنا يطرح السؤال التالي: ما الذي يمكننا فعله لتوخي المزيد من الدقة؟ في الواقع، لطالما اتخذ الفساد أشكالاً مختلفة: العقود الحكومية المبالغ فيها، والإتجار بجميع أنواعه والعمولات واستغلال النفوذ والاحتيال الضريبي والتوظيف الوهمي والأنظمة المفصلة على قياس المحسوبيات وغيرها من الأساليب التي تطال مجموعة كاملة من الاحتمالات.. وفرص ترتبط بالجمارك والإدارات المسؤولة عن إصدار التصاريح، ومشاريع البنى التحتية الكبرى.
لكن الأمر معقد وتزيده طريقة توزيع أموال “الفساد” تعقيداً، وهي التي توزع في الغالب بشكل تراتبي يضمن حصول الوكيل على حصة كبيرة ولكن هذا لا يعني أنه سيحتفظ بها! تفترض اللعبة توزيع جزء على رؤسائه ومرؤوسيه لكي يستمر العمل بسلاسة. وكيف لنا أن ننسى الراعي السياسي وحصته.. الحصة التي يخضع جزء منها بدوره لإعادة توزيع من أجل تغذية ولاء الأنصار.
كيف يمكن تتبع المال في هذا السياق المؤسف بشكل متواصل؟ ألا تتوجب مواجهة استحالة الكشف عن السرقات الصغيرة؟ وماذا عن السرقات والثروات الكبيرة؟ يمكن الكشف عنها بطريقتين، إما من خلال الغوص بشكل تفصيلي في حسابات الدولة الواحد تلو الآخر وإما بتطبيق القانون الفرنسي الذي يتعلق بالإثراء غير المشروع والذي يوجد مقابل له في لبنان.
بالنسبة للطريقة الأولى، أعيد تكوين حسابات الدولة، على حد تعبير مدير عام المالية السابق آلان بيفاني، بالكامل منذ عام 1993، في تقارير تمتد على 53000 صفحة.. في حزم لا يزال يتوجب على ديوان المحاسبة التحقق منها قبل إحالتها في مرحلة نهائية إلى البرلمان. وهو ما لن يتحقق أبدًا بسبب نقص عدد الموظفين الكافي أو بسبب قلة الحماس.. وربما بسبب الإثنين معاً.
أما الطريقة الثانية، التي تستدعي النظر في الإثراء غير المشروع والمؤشرات عليه، فهل يفوت أحد أن ذلك الوزير أو النائب أو المسؤول الكبير يعيش حياة تتجاوز الإمكانيات التي يفترض أن يتمتع بها. ولنأخذ على سبيل المثال، جميل السيد، مدير عام الأمن العام سابقاً. كان يفترض بالسيد أن يكسب ما بين 4 إلى 5 آلاف دولار شهريًا، وهو مبلغ يكفي للعيش بشكل جيد إلى حد ما، ولكن هل يكفي لتجميع ثروة؟ ومع ذلك، كيف به يتحول لأحد المساهمين في “أسترو بنك” القبرصي الذي أنشأه موريس صحناوي مع شركاء آخرين؟ أضف إلى ذلك أن السيد، يخضع منذ تشرين الأول 2021، لعقوبات أميركية بتهمة الفساد، ولا سيما أنه سعى لـ”التحايل على الأنظمة المصرفية المحلية لتحويل 120 مليون دولار إلى الخارج، على الأرجح لإثراء نفسه ورفاقه”، حسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية.
يمكن للسيد الذي أصبح نائباً في ما بعد الرد بالنفي أو ادعاء أنه حصل على ثروته بالميراث، أو أنه فاز بجائزة اللوتو الكبرى أو أن الحظ ابتسم له حين وضع أمواله في استثمار معين. كل ذلك ممكن، ولكن في هذه الحالة يكفي الكشف عن مصدر هذه الثروة لإظهار قانونيتها وإثبات تسديده الضريبة المستحقة. يطالعنا في هذا السياق مثال آل كابوني، الذي لم يستطع القضاء إدانته إلا بتهمة التهرب الضريبي على الرغم من نشاطه الضخم في عصر الحظر! في كل الأحوال، ألا تشبه قصص الفساد حكايات الدولة نفسها إلى حد ما؟ الكل يسمع عنها ولكن هل كشف أيّ كان النقاب عنها؟