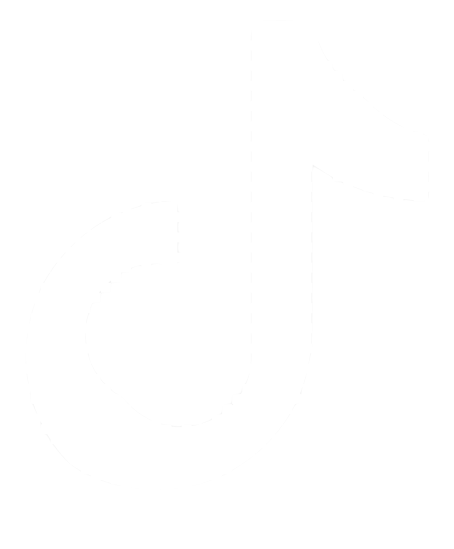عن “المتحرّش” سامر مولوي.. و”المتحرّشين” الذين يحيطون بنا!

كتبت نسرين مرعب لـ”هنا لبنان”:
لا أعرف سامر مولوي، لم ألتقِ به بتاتاً، جمعتني به إحدى مجموعات الواتس آب، حاول مرتين أو أكثر فتح مجال للتواصل معي بشكل “غير مريح”، فصددته! وغير ذلك لم يكن إلاّ عابر..
اسم “سامر مولوي” عاد مجدداً، مع أصوات الطالبات القويات اللواتي قررن فضحه، وفضح تحرّشه وتجاوزاته، واستقوائه، هم طالبات مدرسة جورج صرّاف الرسمية..
الحب الذي حظيت به الطالبات، التعاطف، الدعم، أعادني كثيراً إلى الوراء، وتحديداً إلى المدرسة الثانوية وسنتي الأولى بها، وأستاذ الفيزياء.. أذكر تهامس الرفيقات حول محاولاته المتكررة للمسهنّ واحتضانهنّ، كان الحديث يدور خلسة، فالأستاذ “مدعوم”، ونحن كنّا ضعيفات، كنّا لا نعلم ما هو التحرّش، وأنّ ما نتعرض إليه هو انتهاك!
أذكر، يوم كان مراقباً لي في الامتحان، وكيف دنا مني وتلمّس ظهري من فوق “الجاكيت”، وهمس بأذني “شو هيدا كلو” في إشارة إلى جسدي الذي كان ممتلئاً وقتها. غريبٌ أمر هذه الكلمات كيف ما زلت أسمعها وكأنّني سمعتها بالأمس.
يومها، لم أتكلم، لم أكن ببساطةٍ أعي ما يدور حولي!
في الجامعة لم تختلف الصورة، فالمتحرّش موجود في كلّ مكان.
أذكر أحد أساتذة سنتي الأولى، وكيف كان يربط النجاح بأمرين، أو زيارة خاصة إلى مكتبه، أو مبلغاً مالياً. كان دائماً يوّجه لنا نحن الطالبات التعليقات التي تحمل أبعاداً وحده يدرك معانيها، ذات مرّةٍ شبّهني بامرأة “قيس” لم أعلّق، آثرت الصمت، أما عيون صديقتي الخضراء فلم تكن تسلم من تعليقاته السخيفة!
صديقتي اختارت أن تدفع له، كان المبلغ في ذلك الوقت 150 ألف ليرة، أما أنا فكنت من الطالبات اللواتي رفضن الامتثال لشرطيه، فاجتهدت ودرست كي أقدّم الامتحان وأجتازه رغماً عنه، وحينما زارنا يوم التقديم في غرفة الامتحان اقترب من زميلة ووضع يده على يدها وبقي لدقائق إلى جانبها وقبل أن يفرج عنها أخيراً وضع إشارة على ورقة الامتحان التي كانت تقلّب فيها.
حاول تكرار الأمر معي، بل وطالب بنقل مقعدي من أوّل القاعة إلى آخرها. لم أفسح له المجال، صددته قبل الاقتراب وقلت له “شكراً مرتاحة في هذا المكان، وليس لدي لا سؤال ولا استفسار”، امتعض مني.. وحينما صدرت النتائج بعد أيام طويلة، اكتشفت أني اجتزت المادة “على الحفة”، فيما تلك الفتاة ومن زُرنه، ومن دفعن له، كانت الدرجات العالية من نصيبهن.
لصديقتي رواية أخرى مع التحرّش في الصرح الجامعي، فوالدها كان متوفيًّا، وكان هناك دكتور في الستينيات، يعاملها كابنة، هكذا كانت تظن، حتى فوجئت به بأن طلب منها في إحدى المرات إرسال صورة إليه عبر “الواتسآب” وهي تقوم بحركة غير لائقة! دهشت صديقتي سألتني ماذا تفعل؟ خاصة وأنّ الدكتور هو المشرف على رسالتها!
وببراءتي المعهودة وقليلٍ من الضعف، أجبتها “طنشيه”. في حينها لم يكن أحد يصدقنا، كنّا مستضعفات!
هذه الحوادث وغيرها أسردها، لكل من يقول “عادي”، “مش صدمة”، “بتصير”.. أسردها لكل من يضع التحرّش في قالب “الطبيعي”!
ما من شيء عادي، فصور الشبان الذين كانوا ينتهكون حرمة مدارسنا بأعضائهم التناسلية من خلف الجدار لم تمحُها 20 سنة، وأصوات الذين كانوا يقفون أمام بوابة المدرسة كي يقذفونا بعبارات قذرة، ما زالت عالقة في أذهاننا!
لا شيء عادي.. فالمتحرّش الذي عبر في حياتنا ما زال يخيفنا!
مواضيع مماثلة للكاتب:
 تحذير إسرائيلي.. “وعاد الكابوس المرعب”: شكراً للحزب!! |  مواجهة “العنف” بـ”العنف”… “كفى” تستخدم الدعاية الإسرائيلية للتّرويج! |  “غزة”.. يا ليته كان انتصاراً! |