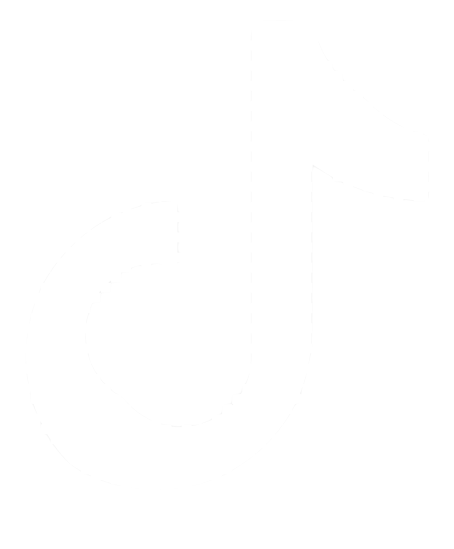عن الروحانية المارونية

كتب أمين اسكندر لـ”Ici Beyrouth”:
إن روحية التضحية التي طبعت سكان الجبل ليست مجرد مرادف للعزلة أو للنأي بالنفس عن ثروات هذا العالم، بل هي أساس الحرية التي ارتبطت في نهاية المطاف بالكيان اللبناني بحد ذاته.
فلبنان أبصر النور في المساكن والحقول المتدرجة في فلك الأديرة.. وتوسع بفضل صبر ونفس طويلين وبمثابرة طويلة الأمد، تماماً كما تنحت قطرات الماء تلك الصواعد المخروطية في المغاور بشكل أعمدة متراصة.. بصبر وتكتم تام. وهكذا، في الدولة العثمانية، التي نصبت نفسها دولة الخلافة، أعيد بناء قرى الجبل وتوسيعها وتطويرها وازدهارها بكل هدوء. ولا يمكن لأي كائن يشهد على هذه المثابرة الأقرب للمعجزة، إلا أن يستوعب الروحانية التي غمرت المجتمع الجبلي بأكمله.
الحجاج في دير مار مارون الواقع في قرية عنايا، يطلعون على إعادة تمثيل لبيت العائلة التي كبر القديس شربل في كنفها إلى جانب والديه وإخوته وأخواته. وتؤكد سيرة القديس الذاتية على إخلاص أفراد عائلته وتحديداً والدته بريجيتا. ويدفع مشهد البيت للتفكر في كل تلك البيوت المميزة التي يولد فيها القديسون. ومع ذلك، لم يكن ذلك البيت مميزاً بشكل حصري، فقد طبعت الروحانية والعبادة والأناجيل والعمل في الأرض، الحياة اليومية للقرويين جميعهم.
السنة الليتورجية
ينبض الإيمان المسيحي في قلب المجتمع بأسره وهو الذي يحدد إيقاع الحياة فيه وقيمها وصولاً إلى تطلعاتها. لم يكن هذا الإيمان بأي حال من الأحوال محصوراً بقداس الأحد أو بصلاة المساء، بل طغى على كل منعطفات الحياة فأدارها ونظمها، ليس كدين فحسب وإنما كروحانيات. وتجسدت هذه الروحانيات في التواضع والتضحية والبساطة، وفي السنة الليتورجية التي قسمت بالنصف بين فترة الصوم وفترات تقيّد فيها بعض الأطعمة. أما الصلاة فحاضرة مع كل وجبة طعام وعند الاستيقاظ والنوم. وتحضر الروحانيات أيضاً في أعمال الأرض حيث تحرث الحقول وتبنى المدرجات ويمارس الحصاد على إيقاع الترانيم السريانية التي تكرر آيات من الكتاب المقدس.
على الرغم من أنه قد يخيل أن الأعياد في التقويم الليتورجي هي الأهم بالنسبة للمجتمع، إلا أن الصوم هو الذي كان شغله الشاغل وإيقاعه الناظم. الصوم.. لحظة الحرمان التي ترادف نوعا من الإتحاد مع المسيح، في حالة من “الرفقة أو رحلة يقودها يسوع نفسه” على حد وصف المطران سيمون عطا الله. أما الاحتفالات فتأتي في المرتبة الثانية، كتحقيق لتجربة هذا اللقاء مع الإله واستقباله. المجتمع بأسره كان في حالة من الذوبان التام مع كنيسته حسب نموذج القديس يوحنا فم الذهب الذي لا يجد بين الرهبان والعلمانيين أي فرق، ربما عدا عن مسألة المساكنة.
العائلة
يضمن هذا الشكل من الإيمان الأخلاقي الواعظ، على حد تعبير الأب ميشال حايك، التواضع وروح التضحية التي تشكل حجر أساس في مشروع تقدم البشرية النبيل. واتخذت العائلة المارونيّة، مثال العائلة المقدّسة وحاولت اتباعه قدر الإمكان. ووفقًا لهذا التصور، ليست القداسة ثابتة في المكان ولا في الزمان. ولا تقتصر على الصوامع أو الأديرة، كما لا يمكن بلوغها تماماً، فهي في حالة من التطور الدائم كما يقول الأسقف جبرائيل باركليوس، بالتوازي مع مرافقة المسيح، في التجربة الفردية والمجتمعية على حد سواء.
وتمحورت حياة القرويين حول القربان المقدس، فتركزت تحضيرات الأسبوع بأكمله حول خبز الذبيحة والتحضّر لهذه اللحظة للترحيب بجسد يسوع. واجتمعوا حول هذه القيمة المركزية التي عبر عنها البطريرك إسطفان الدويهي بوضوح، لتشكيل ما يسميه جاد حاتم بـ”جماعة الأفخارِستيا”. وعلى هذا النحو قاموا بتكوين وهيكلة مجتمعهم، بدءًا من رعاياهم. حتى أن ذلك تجلى لغوياً في ربطهم الكنيسة بمصطلح “كنوشتو” (knoushto ) الذي ينمّ عن التجمع والجماعة.
لقد بني لبنان في وحي من هذه الحالة الذهنية، بين إبادتين جماعيتين اختبرهما في 1283-1307، و1914-1918. ففي العصور الوسطى، دمرت البلاد على يد المماليك البلاد وأفرغت من سكانها ومسحت غاباتها عن بكرة أبيها وجرفت قراها وهجر سكانها. وخلال الحرب العالمية الأولى، تسبب العثمانيون بمجاعة خسر جبل لبنان على إثرها، ثلثي سكانه بسبب الموت والنزوح. ولكن ما الذي حدث في الفترة الفاصلة بين هاتين الكارثتين؟
في بداية القرن الرابع عشر، تقلص عدد السكان المسيحيين لينحصر في منطقة تقع بين تنورين وجبة بشرّي. دمرت جزين ودير عمار وجميع قرى وأديرة المتن وكسروان. كانت البطريركية المارونية قد نجحت في الحفاظ على نفسها في إيليج حتى العام 1440 ، التاريخ الذي توجب فيها الإختباء في دير قنوبين في قاديشا. واستمرت هذه الحياة شبه الكهفية حتى اندحار المماليك أمام العثمانيين في العام 1516، إيذانًا بعصر جديد.. عصر لم يعرف فخامة كنيسة القسطنطينية أو روما أو بكركي، بل عصر من الصلاة والصوم والحراثة حيث عاش الفلاحون والأساقفة والآباء في بساطة شديدة لم تنتقص من اكتفائهم الذاتي. وأعيد بناء جميع القرى اللبنانية خلال هذه القرون الأربعة، أي بين 1516 و 1914.
إعادة الإعمار
تطورت حركة الإعمار من الشمال إلى الجنوب. أولاً باتجاه العاقورة وجبيل، ثم باتجاه كسروان والمتن والشوف وجزين وصولاً إلى القليعة وما بعدها. توجب على الفلاحين في كل مكان، حفر الأرض للعثور على أساسات الكنائس التي دمرها المماليك قبل قرنين من الزمان. كان عليهم العمل كمزارعين قبل أن يتمكنوا من تخليص أرض أجدادهم.
في تلك الفترة، لم يستولِ أحد على أي حقل بقوة السلاح ولم تُسترد كنيسة أو ديرًا بالحروب. كل شيء كان ثمرة العمل الدؤوب، والتعاون الوثيق مع الكنيسة والحفر في أرض معالم الإيمان حتى أصبحت رموزاً للاستقرار والتطور. فبات الدير هو المستشفى والمدرسة ومبنى البلدية. ومن خلال علاقاته مع توسكانا وروما وفرنسا، استقدمت تقنيات جديدة للزراعة وللخَبز وللصيدلة والبناء. وما كان باستطاعة الدير فعل كل ذلك بدون الناس.
وبعيدًا عن اختزال الدين في عرض المعالم الإقليمية، عاش المجتمع إيمانه في جميع مجالات الحياة اليومية. وأعادت هذه الروحانية العميقة والارتباط بجسد المسيح بناء لبنان من الشمال إلى الجنوب. ورافقت الروحانية نفسها الرحالة أو المبشرين المستشرقين، وشعوب بلاد الشام الأخرى التي لم تستطع إلا الشعور بها، فرأينا مراراً قيام شيعة ودروز بتمويل أو المشاركة في تمويل بناء كنائس على غرار كنيسة السيدة العجائبية في بسري.
التحرير والحرية
تكمن قوّة بناة القرى المعلقة على سفوح لبنان، في تواضعهم وتفانيهم وبساطتهم الشديدة. بالنسبة للمطران سيمون عطا الله، لم يكن هذا الزهد مجرد انعزال أو نأي بالنفس عن ثروات هذا العالم، ولكنه قبل كل شيء، تحرير للروح وللقلب. وهكذا، عاش الموارنة روحانيتهم في حياتهم اليومية، حتى أصبحت أساس حريتهم التي سترتبط في نهاية المطاف بكيان لبنان ذاته.
هذه الكنيسة المضطهدة، المتجذرة في كهوف قنوبين، هي التي أعادت بناء لبنان بين 1516 و 1914 تحت نير الحكم العثماني. وقد نجحت من خلال الاستلهام الروحي من السماء، بالانتشار على الأرض وبترسيخ روح المسيحية وقوتها. وأي شيء أصدق تعبيراً عن التاريخ العظيم لبناء لبنان، من نداء المطران الدويهي الذي أمل فيه استعداد الكنيسة المارونية لأن تصلب من أجل أن تربح قضيتها؟