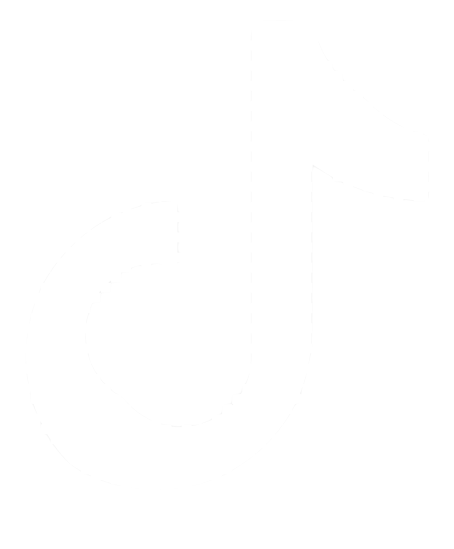الطائفية السياسية والتمييز الإيجابي

النظام اللبناني الطائفي، الذي ينصّ على التقسيم و المحاصصة بين الطوائف، هو الأسوأ. فبعض البلدان، بغية تصحيح المظالم الاجتماعية، لجأت بغياب أي بديل أفضل إلى سياسة التمييز الإيجابي أو “العمل الإيجابي”. الأمثلة تفيض ومنها الفوائد التي عادت على الأميركيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة. فماذا لو كان النظام الطائفي في بلدنا، هو مجرد شكل متقن من أشكال هذا التمييز الإيجابي؟
كتب يوسف معوّض لـ”Ici Beyrouth“:
لا شيء أسهل من إلقاء اللوم على نظامنا الطائفي البالي، ولا شك بأن هذا النظام لطالما شكل أساساً للفساد وللمحسوبيات وللحروب الطائفية. وهذا ما حدا بالبعض إلى اقتراح تجربة العلمانية كما لتنظيف “إسطبلات أوجيان” بلمح البصر.
جيراننا السوريون لم يتوقفوا يوماً عن انتقادنا بسبب نموذجنا القديم في تقاسم الكعكة بين الطوائف. ولم يكلوا لفترة طويلة، من تكرار النصح على مسامعنا، على أساس أن بلدهم لا يفرق بين أحد وآخر، وعلى أساس أن تقييم السنة والعلويين والدروز والإسماعيليين والمسيحيين يمرّ حصرًا بباب الجدارة. وكان ليخيّل للمستمع إليهم أن المواهب والخبرات، تحسم وحدها المناصب في الإدارة في عهد الأسد الأب والابن، وتحديداً في السلك العسكري وفي المخابرات. ثم فجأة، واعتبارا من العام 2011، صمت العلمانيون البعثيون. وكشفت حربهم الأهلية الكذبة الوقحة الملمّعة التي تأسست عليها دولتهم، وأُطلق العنان لأكثر الغرائز الطائفية لدى الجحافل البرية!
حول مبدأ التمييز الإيجابي
لجأت بعض البلدان، ومن ضمنها البلاد الأكثر تطوراً في العالم مثل الولايات المتحدة، لسياسة التمييز الإيجابي أو العمل الإيجابي لتصحيح الظلم الاجتماعي، باعتباره البديل الأفضل. وتتمثل هذه السياسة بمنح معاملة تفضيلية لفئات معينة من السكان، بهدف تحسين فرص التقدم الاجتماعي لأفرادها. وهل بالإمكان فعل شيء آخر لإفادة الأشخاص المحرومين في البداية؟ من المؤكد أن منح وظائف معينة لأولئك “المتخلفين عن الركب” مقارنة بالآخرين هو انتهاك لمبدأ المساواة المقدس. لكن يبقى بالإمكان الإسهاب بشكل صحيح لتقرير مصير المجموعات المهمشة تاريخيًا، لتصحيح الظلم الاجتماعي، وحالة الأميركيين الأفارقة هي مثال نموذجي.
فلماذا لا نعتبر النظام الطائفي اللبناني شكلاً مفصلاً إلى حد ما للتمييز الإيجابي المذكور؟
لهذا النظام ألقاب عدة وجذور تاريخية، فهو ليس ثمرة ابتزاز أجنبي كالعلمانية المتعنتة التي لن تتردد في زعزعة الواقع الاجتماعي. كما أثبت هذا النموذج من الحكم نفسه، حيث ساعد على تحريرنا من المأزق حيث حاصر الإسلام المتشدد أهل الذمة، أعني بهذا المعارضة الألفيّة والمجمّدة التي تكرّس الاختلاف في المكانة بين “أتباع” محمد والناصريين.
إرث تاريخي
تعود صيغة تقاسم السلطة السياسية بين الطوائف الدينية لمنتصف القرن التاسع عشر، حيث أكدت الحداثة الأوروبية نفسها لتنتصر في مواجهتها ضد الإمبراطورية العثمانية. وأجبرت هذه الأخيرة، على تحديث النظام خوفاً من تلاشيه، وأطلقت منذ العام 1839 سلسلة من الإصلاحات والتنظيمات، “لتشكيل مجتمع عثماني يقوم على ولاء جميع العثمانيين للإمبراطورية. وهدف هذا المشروع العثماني، على المدى البعيد لبناء مجتمع يضم أفراداً متساوين أمام الدولة، لكن حتى فرمان “شريف همايون” في عام 1856 أظهر حقيقة دفعت للاعتراف بالجماعات الطائفية باعتبارها البنية الحقيقية للمجتمع العثماني، في إطار تعزيز مأسستها القانونية… ثم أصبح المجتمع الديني كيانًا غير إقليمي يتمتع بحقوق دينية وسياسية وثقافية”. وهكذا لن تولّد الإصلاحات أفرادًا مستقلين على غرار المجتمعات الليبرالية الغربية. لا بل على العكس، ستزيد من تمكين الهوية الطائفية. وكنا حينها على وشك أن نرث هذا التحديث نتيجة الإصلاحات.
هذا يعني باختصار أنه ليس بإمكاننا تغيير المجتمع بمرسوم وقد صدق المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل حين قال إن العقليات لا تتغير إلا في الختام. ولا شك بأن فكرة المواطنة قادرة بالطبع على التطور، ولكن ذلك سيحصل ببطء؛ وستتخلل رحلتها وقفات مفاجئة وركلات غير متوقعة وتراجع حتى. ويمكننا طبعاً أن نأمل بتحرر المجتمع من قيود الطائفية والتأكيد على إرادته الحرة. لكن كل هذا هش للغاية، ولن يحصل بكل بساطة بين الليلة وضحاها!
العلمانية غير العملية والسيناريو الطائفي
في الشرق العربي الإسلامي، يمكن للجماعات البشرية التي تلتف حول هويتها الجماعية الحذر من هزات التاريخ السياسي. وقد تكون ما تسمى بالمساواة، التي يحدث البعض ضجيجاً كبيراً حولها، مجرد شعار فارغ، لا يراد به إلا هيمنة طائفة على أخرى، كما الحال في سوريا.
أما بالنسبة للعراق، إذا أخذنا المصير البائس للأيزيديين منذ عام 2014 في عين الاعتبار، فلا يمكننا تجاهل درجة نبذ المسيحيين هناك رغم إعادة إرساء السلم الأهلي. ففي هذه اللحظات بالتحديد، يحتجّ البطريرك الكلداني لويس ساكو ضد احتلال الأحزاب السياسية ذات الأغلبية المقاعد المخصصة للمسيحيين في البرلمان”. ليست مجتمعاتنا علمانية لدرجة السماح بإجراء التجارب العلمانية من قبل “المتدربين السحرة”! أليس كذلك؟ في مصر، نجا الأقباط بأعجوبة. لم يكف وصول محمد مرسي إلى السلطة في حزيران 2012، بالإنتخابات ليطمئنهم. فالإنقلاب العسكري، الذي يستحق الشجب في المبدأ، للجنرال السيسي، في تموز 2013 ، منح كحد أقصى 10٪ من سياسة التمييز المقنعة الذي كان الإخوان المسلمون سيفرضونها. هذا يعني أن القاعدة الديمقراطية للأغلبية لا تؤدي بالضرورة لتحسين أوضاع الأقليات ؛ لا بل انها تميل بخدعة التاريخ أحيانًا لإرباكهم ولا تقدم لهم أي ضمانات بهذا المعنى.
طالما أن هوية الطائفة هي القاعدة التي نبني عليها كل شيء وطالما أن عقلياتنا مغلقة بنص طائفي، سيبقى منطق الحصص أهون الشرور. ولن نتمكن من التخلص من نظامنا الطائفي إلا على حساب الظلم الجسيم الذي يلحق بمجموعات معينة. ظلم اتخذ عبر التاريخ أشكال الاضطهاد والمجازر والتمييز..
مواضيع ذات صلة :
 “الفدراليّة” على مائدة العشاء! |